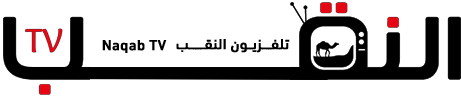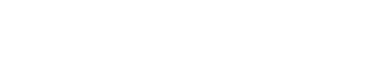يومًا ما سيحكمون! بقلم: المحامي يحيى دهامشة

بدأت أفكار هيغل بالتغلغل في المدارس الفكرية خلال القرن التاسع عشر، كما بيّنا في المقالة السابقة.
وكان من أهم تلامذة هيغل: كارل ماركس، الذي وضع منظومة كاملة لحركة التاريخ والنشأة البشرية، بل ووضع تصورًا أو تنبّؤًا- على وجه أدقّ- لمسيرة التاريخ وكيف سيستمر، إلى أن تثور الطبقة العاملة. فقد كان يرى بأنّ مهمته الأولى هي الكشف عن قوانين التطور للمجتمع.
بعض المفكّرين الأوروبيين لم يفهم سرّ السحر الاشتراكي وقوّة جذبه بالأخصّ للطبقات التي تسمّي نفسها بالمثقّفة و”النُّخَب” وما إلى ذلك من الفئات المحسوبة اليوم على الطبقة المتوسطة. لكن قلة من المفكّرين الأوروبيين فهم ذلك جيدًا منذ البداية، بيد أن آراءهم لم يكن لها اعتبار أو أهمّيّة في حينه، لأنّ تقديراتهم لما سيؤول إليه هذا الفكر من فشل، لم تكن لتُدرك أو تُستوعب أمام السّحر الذي يحمله، ويبدو أنه كان لا بد من خوض التجربة، كي يتم استيعاب ما حذّروا منه.
فمن ذا الذي يمكن أن يتفوّق على خطابٍ يتحدّث عن الضعفاء وحاجاتهم والظلم الذي يحيق بهم؟ وهذا لا يختلف فيه اثنان فيهما ذرّة من إنسانية، ولكنّ الكوارث تبدأ مع تحليل أسباب التمييز بين البشر، وادّعاء وضع الخطط لتحطيم هذا التمييز والزعم بأنّ المنظومة التي يُنَظّرون لها هي ما ستحقّق في النهاية- المساواة والعدالة الاجتماعية.
كان فيلفريدو باريتو الذي نشط ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أهمّ الاقتصاديين الذين فهموا منذ البداية فشل المنظومة الاشتراكية، عقودًا قبل وصولها إلى الحكم. ولكنّه كان على قناعة أيضًا، أنّ هذه المنظومة ستحكم وتسيطر يومًا ما. وفسّر ذلك في أنّ هذه المنظومة في الحقيقة عبارة عن قناعات دينيّة دخلت إلى السياسة، حتى غدت في مرحلة معيّنة عبارة عن بديل جديد للأديان القائمة رغم بغضها ومقتها لهذه الأديان ولكلمة دين من الأساس. فالانطلاق من قناعات لا تقبل النقاش حول سير التاريخ ومآلاته وتفسير الصراعات بين القوى المحركة لهذا التاريخ بإيمان مطلق، هي في الحقيقة قناعات دينية مهما حاولت تسميتها “سياسيّة” لمقتك ونفورك من كلمة “دين”.
فعلى سبيل المثال، استمرت الأحزاب الاشتراكية (اليسارية منها) بالإيمان بـ”نظرية قيمة العمل”، وهي نظرية أسّس عليها كارل ماركس تصوره الاقتصادي. واستمر الاعتقاد بها وبصلاحيتها حتى بعد أن هجرها معظم خبراء الاقتصاد المعتبرون، لمّا ظهر في ما بعد ما ينقض هذه النظرية ويقوّض أركانها.
وبالفعل فقد بدأت هذه الحركات في الوصول إلى السلطة سواءً عن طريق ثورات أو عن طريق الديمقراطية، في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، وبدأت الدول المبنيّة على المنظومة الاشتراكية، سواءً اليمينية منها أم اليسارية في السيطرة على كل مفاصل الدولة ووسائل الإنتاج والمقدّرات والموارد، وبدأت مرحلة بناية الأنظمة الشمولية التي ظهرت كدول عظمى في حينه.
كان عامل القناعات السياسية المؤدلجة في قالب عقائديّ دينيّ من أهمّ العوامل التي ميّزت الأحزاب والحركات الاشتراكية في بداية القرن العشرين. أضف إلى ذلك عامل التخطيط لبناء المجتمعات العظيمة والمثالية في أجواء كانت البشرية تعيش ما سمي حينها بـ”هوس التخطيط”، والذي يمكن توصيفه بالشعور البشريّ بأنّ الإنسان قادر على تخطيط وهندسة كل شيء يريده، بما في ذلك بناء مجتمع بشريّ خالٍ من الظلم والتمييز. وأدّى رواج هذه الأفكار في الجوّ السياسيّ العام منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تقبّل برامج سياسيّة تنادي بوجوب تغوّل الدولة ومركزيّة السلطة والسيطرة على حياة الفرد، حيث بدت هذه الأفكار مقبولة جدًا ومعقولة بل ضرورية من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة.
من أقرب الأمثلة التي يمكن أن نعيها عندنا بخصوص هذا الفكر وعن كونه عبارة عن قناعات دينيّة عقائدية، ما كان في انتخابات الكنيست الـ 25. فرغم كون جمهور الحزب الشيوعي والجبهة بالذات، أكثرَ جمهور مستاء من قياداته ومن الوضع الذي أفضى إليه الحزب، ورغم أن جزءًا كبيرًا من أتباع الجبهة ومؤيّديها لا يختلفون مع الطرح الذي جاء به خصومهم من القائمة العربية الموحدة ود. منصور عباس، ورغم ما رأوه من سلوك سياسيّ متناقض لقيادات الحزب، وكيف سارت على مدى عام ونصف تعادي نهج التأثير وتروّج لعبثيّة دخول الائتلافات الحكوميّة وزعم إمكانية تحقيق ما حقّقته الموحدة في الائتلاف من صفوف المعارضة، بعدها خرجت فجأة إلى جمهورها في الحملة الانتخابية بأنّها مع التأثير (ولكن بكرامة)، ما أحدث تخبّطًا جدّيًّا عند جمهورها، إلا أنّ هذا الجمهور ورغم كل ذلك، لم يتورّع في الخروج في يوم الانتخابات والتصويت لحزبه. فدعم الحزب لا يأتي وفق قناعات سياسية تتماشى مع خطّ الحزب السياسي، بل هي قناعات من منطلقات عقائدية تؤمن بواجب الولاء والانتماء للحزب وفكره بغضّ النظر عن إخفاقه السياسي، وهذا بالضبط هو الدين والعقيدة.. لا السياسة.
قد يرى البعض هذا الأمر نقطة قوّة للحزب. وهذا صحيح، ولكنّ حزبًا من هذا النوع في النهاية يبقى حزبًا قائمًا من أجل ذاته ولخدمة ذاته، ولن يكون في يوم ما قادرًا على استيعاب الدائرة الأوسع من مجتمعه، فهو يعبّر في نهاية الأمر عن قناعات أيديولوجية عقائدية مشتركة لأفراده، لا عن نهج سياسي. وكما ذكرنا وبيّنا أيضًا من خلال المقالات السابقة بخصوص فشل المنظومة الفكرية، فإنّ قوة العقيدة أو نجاحها في حفظ الحزب والحركة لا تعني بالضرورة صحة المنظومة الفكرية لهذه الحركة أو الحزب فالأمران يختلفان.
وهنا قد يُحدث الأمر التباسًا عند القارئ وقد يقول قائل: كيف لك أن تدّعي ما تدّعيه وأنت بنفسك ترأس المكتب السياسي للحركة الإسلامية، وهي حركة دينية تخوض في العمل السياسي؟. أقول: هذا صحيح، فهذا بالضبط ما يميّزنا، أنّنا في الجانب العقائدي الديني متصالحون مع أنفسنا ومع مجتمعنا، ونحن لسنا بحاجة لتبنّي منظومة فكرية غريبة عن مجتمعنا ونبقى في حالة صراع مستمر للتوفيق بين أفكارنا وبين المجتمع، أو أن ننافق للمجتمع ونبطن من أفكارٍ ما لا نظهره، لكي نتجنب الصدام معه. عدا عن أن الولاء عندنا للمجتمع ذاته، فالسياسة عبارة عن منظومة عمل لتخدم المجتمع، وليست أفكارًا أيديولوجية يتوجّب علينا بناء وهندسة المجتمع وفقًا لها. وتبقى مساحة العمل السياسي عندنا في الموحدة أوسع بكثير من مساحة العمل السياسي عند الأحزاب أو الحركات العقائدية الأيديولوجية بشكل عام، لأنّ هذه الحركات، كما ذكرنا أيضًا من خلال المقالات السابقة، تعمل وفق منظومة عقائدية لا يمكن تجاوزها، وهي عبارة عن توجّه من أجل بناء تصوّر مثاليّ معيّن، بينما العمل السياسيّ في القائمة العربية الموحدة، مساحته أوسع بكثير- وهو عكس المنظومة الأيديولوجية- حيث لا تلهث لبلوغ تصوّر مثاليّ لشكل معيّن للدولة (دولة المساواة والعدالة الاجتماعية أو دولة جميع المواطنين)، بل تعمل بحرّيّة تامّة في السياسة، من أجل تحقيق أهداف لأمور يمكن رصدها وتقييمها. كخطط لتحقيق مشاريع معيّنة وواضحة لعلاج أزمات معيّنة، كمشكلة العنف والجريمة وأزمة الضائقة السكنيّة في البلدات العربيّة وما إلى ذلك. بل إنّ هذا الأسلوب في العمل السياسيّ، أقرب إلى تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وأكثر فاعليّة من اللا-أسلوب الذي يدّعيه الخصوم من خلال طرح الشعار فقط.
بمعنى آخر؛ هناك فرق في العمل السياسي في إطار منظومة أيديولوجية توجب عليك التصرف الدائم وفق المنظومة لتحقيق التصوّر المثالي (كما هو في حالة الجبهة والتجمع)، وبين منظومة عمل سياسيّ واقعيّة ترى أنّها تعمل في مساحة واسعة وفق كوابح مرجعيّتها الشرعية والقانونية عندما تمنعها هذه المرجعية من مسلك معيّن ينافي الشريعة أو ينافي القانون (كما في حال الموحدة). يمكن أن نقارب إلى القارئ الفرق بين التصوّرين كأنْ تعيش في نظام يفرض عليك قيادة مركبتك، فيما يقرّر لك النظام ما هي وجهتك، وما هي الطريق التي يتوجب عليك سلوكها، ويقرر لك مسبقًا متى عليك التوجّه يسارًا ومتى يمينًا ومتى عليك أن تستمر في السير المستقيم، وبين نظام آخر يتيح لك أن تحدّد أنت الوجهة وبعدها تختار التنقّل بحرية لبلوغها، مع واجبك أن لا تتجاوز إشارات المرور.
لكن، مهمّ جدًّا أن ننوّه استمرارًا لما ذُكر في المقالة السابقة، بخصوص تأثير الفكر الاشتراكي على حركات إسلاميّة لها مكانتها في القرن العشرين، وعلى الفكر الحركيّ عندها بشكل عام. فإن كانت هذه الأفكار عبارة عن بديل للدّين وعن قناعات عقائدية في السياسة عند حركات إلحاديّة وعند مفكّرين يصرّحون بإلحادهم ويؤسّسون نظرياتهم من منطلق ماديّ إلحاديّ، لكم أن تتصوّروا كيف كان الأمر في شرقنا الإسلاميّ بكونه أكثر تعقيدًا. فإن كانت الاشتراكية في الغرب عبارة عن دين جديد، لكنّها دخلت في شرقنا عن طريق المنظّرين الإسلاميّين بثوب إسلاميّ أدّى إلى إعادة صياغتها من جديد، الأمر الذي كان سينتج عنه بالضرورة خلقُ بلبلة مع الدّين وتشويهٌ له. وهذا كان برأيي من أهم الأسباب التي أدّت في مرحلة معيّنة إلى ولادة حركات تكفّر المجتمع وتدعو إلى تشكيله من جديد، وفقًا لتصوّرها المثالي.
وكما سحر الخطاب الاشتراكي في الغرب قلوب الناس، كذلك كانت فاعليته في شرقنا. فكما خاطب اليمين الاشتراكيّ قلوب الألمان، ووعدهم بالسيطرة على العالم، كونهم ينتمون ببساطة لعرق متفوّق؛ وخاطب اليسار الاشتراكي قلوب العمّال ووعدهم أيضًا بقرب سيطرتهم، كونهم ببساطة طبقة البروليتاريا؛ خاطبت هذه الحركات المسلمين على أنّهم المدّ القادم، وأنّهم على وشك السيطرة على العالم، لأنّهم ببساطة مسلمين، بعد أن تم توظيف القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من أجل تفسير حركة التاريخ ومآلاته، تمامًا كما فعل سابقوهم في الغرب وفق ما زعموا بأنّه تفسير علميّ.
كاتب المقال : رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية والأمين العام للقائمة العربية الموحدة